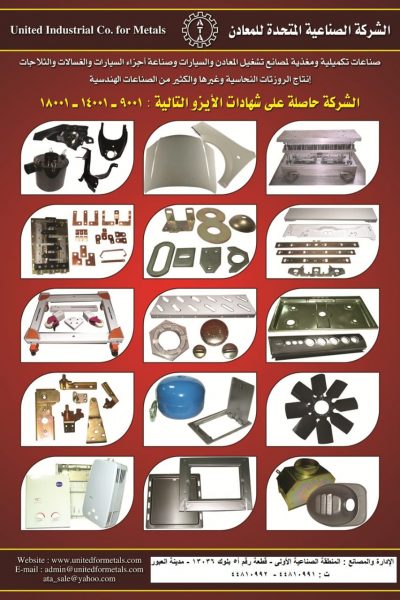في هذه الأيام أنادي قلمي: لنكتب عن الحدث المجيد الذي يفخر به كل المصريين والذي تجلى منذ خمسين سنة..
فيرد علي: إنها ملحمة، وأي ملحمة، إنها اقتحام مانع قيل عنه أنه يستعصي على كل محاولة فهو أفضل وأحدث من خط ماچينو وخط دفاع أوروبا في الحرب العالمية الثانية، يا صاحبي اعفني من شرف الكتابة عن هذا الحدث حتى لا يحترق سِنّي من شدة الانفعال لبطولة من تمكنوا من هذا الإنجاز.
ولكني صممت خاصة أن هذا الحدث العظيم يتعانق مع المولد النبوي الشريف في هذا العام، فلأبدأ بالترحم على أرواح الشهداء وأواسي الذين مازالوا يعانون من إصاباتهم، لعل هذا المقال يخفف بعض ألامهم.
عندما بدأ قائد الجيش الإسرائيلي “بارليف” بناء حاجز رملي على ضفة القناة الشرقية في عام ١٩٦٩ سخر منه الخبراء العسكريون؛ قالوا: التاريخ أثبت أن الحواجز الثابتة لم تمنع خصما إذا كان مصمما على اختراقها وأمثال ذلك كثيرة من حائط الصين العظيم عبر قلعة “مارينبورج” في ألمانيا ذات الجدران بسمك ٣٠ مترا وأخيرا “خط ماچينو” الفرنسي الذي التفت الدبابات الألمانية حوله وتركته سليما.
ولكن تفكيره كان عكس ذلك لأن الوضع هنا مختلف، فالحاجز الرملي بخلاف البناء الاسمنتي لا يتأثر كثيرا من قصف المدفعية لأن القذائف لو انفجرت سيطير الرمل إلى أعلى ثم يهبط مكانه وإذا انغرست القذائف في الرمال دون أن تنفجر فهي إضافة لملايين الألغام الإسرائيلية التي تمنع أي مهاجم من تسلق هذا المانع الذي يبدو سهلا لأول وهلة، لأنه يخفي ما يضمره من اهلاك كل من يقترب منه.
إمعانا في إعاقة تخطيه وُضعت خزانات زيت سريع الاشتعال أسفل النقط المنيعة وفوقها مخزن الذخيرة يليها أماكن النوم وفوقها الغرف الدفاعية، بذلك كانت الذخيرة والزيت على عمق كبير يتعثر معه تفجير أحدهما، وكانت خزانات الزيت هي خط الدفاع الأول في نظره لأنها متصلة بطلمبات تدفع الزيت خلال أنابيب إلى سطح ماء قناة السويس، وهناك ينتشر الزيت بسبب خفة وزنه عن الماء المالح على سطح القناة فلا يبقى إلا إشعاله ليحوّل القناة إلى حاجز من نار يلتهم المهاجمين بقواربهم.
وعند افتراض تخطيه جدلا – وهذا مستحيل في نظره – خبأ عددا كبيرا من الدبابات في وديان في منتصف سيناء لكي تنطلق إلى مكان العبور أيا كان على طول القناة أو أي من شواطئ سيناء والقضاء فورا على أية محاولة لإنشاء رأس حربة، وهي بداية أي اختراق في الحروب.
أما الالتفاف حول خط بارليف كما حدث في الحرب العالمية الثانية لخط ماچينو فهو خارج التصور لأن نقل القوات بالسفن إلى شواطئ سيناء سواء الشمالية أو الجنوبية كما فعل الحلفاء عند غزو أوروبا في الحرب العالمية الثانية سيعرّض السفن للتدمير قبل أن تصل إلى الشواطئ نظرا لتفوق سلاح الجو الإسرائيلي، وهذا الأخير لم يكن يهاب شيئا إلا سلاح الدفاع الجوي المصري وهو الجيش الوحيد – حسب علمي – الذي يندرج في صفوفه بجانب الأسلحة التقليدية – القوات الأرضية والبحرية والطيران – سلاح الدفاع الجوي الذي ابتدعته عبقرية القيادة العسكرية المصرية لكسر شوكة السلاح الجوي الإسرائيلي. وهذا السلاح، رغم كفاءته الفذة، لا يصل مداه إلى شواطئ سيناء.
شعب مصر هو الوحيد بين شعوب الأرض الذي يستطيع أن ينهل من تاريخه الطويل والمتواصل تجارب وفلسفات تنفعه هو دون شعوب أخرى. هنا سطعت تجربة تحتمس الثالث عند غزو “مجيدو” في فلسطين، إذ كان بديهيا للأمراء المتحالفين ضده أنه سيزحف بجيشه على الطريق الساحلي المنبسط حيث أن الطريق الجبلي ضيق لا يمرر العربات الحربية ويسهل قطعه بعدد قليل من المدافعين، فمن المستحيل أن يخاطر بسلوك هذا الطريق، ولكن تحتمس فكر وخطط، فأمر بفك العربات الحربية وحمّلها على ظهور الخيل، وأرسل كشافته لتأمين الطريق الجبلي ثم سلك هذا الطريق … أي تغلب على المستحيل لمفاجأة العدو فتحقق له النصر.
بعد استعداد شاق أنشئت فيه قناة تشبه قناة السويس في مكان سري وبني على جانبيها سدان أحدهما رملي (بارليف) والآخر طيني – وهو يمثل السد الذي بناه الجيش المصري على الساحل الغربي للقناة ليخفي حركات القوات – وكل يوم تفتح فتحات متقابلة في السدين لتمرير معابر الدبابات وذلك لتدريب فريقين أحدهما للعمل نهارا والآخر للعمل ليلا، حيث لم يكن معلوما في أي وقت من اليوم ستنفذ العملية. وفي اليوم التالي يعاد إصلاح السدين ليعاد هدمهما في اليوم الذي يليه. واستمر الهدم والبناء مع قياس الوقت لعملية الهدم إلى أن اطمأنت القيادة على قدرة التنفيذ السريعة وبالكفاءة المطلوبة.
وذلك بعد استقرار الرأي على استعمال طلمبات الماء ذات الضغط العالي التي اقترحها اللواء باقي زكي يوسف لأنها كانت الأسرع في تجريف السد الرملي.
في هذه الأثناء تم اكتشاف مخطط أنابيب الزيت لإشعال القناة. فكلفت مجموعة الضفادع البشرية بالاستعداد للغطس في القناة ليلة الهجوم وضغط كميات من الأسمنت سريع الشك في فوهات الأنابيب التي تطل على سطح القناة لسدها تماما. هنا كان من الضروري الاعتماد على جودة التنفيذ من ناحية أن كل الفوهات يتعطل سريان الزيت منها لأن فوهة واحدة تكفي لتغطية مساحة كبيرة من سطح قناة السويس.
وبدأ العبور الكبير وقت الظهيرة وهو التوقيت الذي يتعارض مع العلوم العسكرية التي تفترض أن أحسن الظروف لبدأ هجوم هو أول ضوء أو آخر ضوء، وأذكر بقصد “العبور الكبير” لأنه فعلا كبير فقد تفجر فجأة ٨١ موقعا في السد الطيني على طول القناة كلها، بمصاحبة زئير الطائرات التي مرت فوقه في اتجاه الشرق ودوي ألفي مدفع أطلقت في ٥٣ دقيقة ١٠٥٠٠ قذيفة لتدك خط بارليف دكا. أما العدو الذي بدأ جمع قوات احتياطه لإرسال جزء منها إلى الجبهة السورية والجزء الآخر إلى الجبهة المصرية فاستطلع الموقف ليعرف أين رأس الحربة لأن من غير المعقول – في نظره – أن ينشر الجيش المهاجم قواته على طول الجبهة فتضمحل شدة الاختراق المطلوبة في مثل هذه العمليات.
في هذه الأثناء تمكن خير أجناد الأرض من تسلق خط بارليف وتطهير النقاط الحصينة من المدافعين عنها. ولما كانت هذه النقاط متصلة ببعضها البعض تليفونيا، فكان كل موقع يسمع صرخات زملائه عندما تصيبهم نار قاذفات اللهب المصرية فيُسقط في أيديهم وينادون قادتهم لينجدوهم ولكن هيهات أن تأتي النجدة فتتحول النداءات إلى السباب لسوء تدبير قادتهم.
طال انتظار ظهور رأس الحربة – كما كان متوقعا من القيادة المصرية – بما هيأ الوقت الكافي لتقدم وحدات خاصة اختفت في ثنايا الصحراء ومعها أسلحتها المضادة للدبابات. اختبأت هذه الوحدات في طريق خروج الدبابات الإسرائيلية متجهة غربا إلى قناة السويس، وانتظرت بلا حراك إلى أن أصم آذان أفرادها صرير جنازير الدبابات المختلط بزئير محركاتها وهي تلهث متسارعة لتلحق بما أغفلته من ساعات قليلة وهو القضاء على أوهام قيادتهم عن “رأس الحربة”. ولكن تدريب هذه القوات منح أفرادها القدرة على تحمل كل ذلك دون ضجر إلى أن أتت اللحظة المناسبة التي يرى فيها المقاتل المصري دبابة عدوه على مرمى حجر، فيقفز من مخبأه معرضا نفسه – غير هائب – للدهس ليوجه قذيفته إلى موقع الضعف في الدبابة ويطلقها بالزاوية التي تجعل منها نارا متوهجة في داخل الدبابة. فلم تمض إلا دقائق وتوقف طابور الدبابات قبل وصوله إلى هدفه بمراحل، واستطاع أفراد الوحدة أسر قائد مجموعة الدبابات “عساف ياجوري” الذي ركع متوسلا: “اقتلوني برصاصة ولا تذبحوني” وذلك أن قادته أوهموه أن جنود مصر سيذبحونه لو ظفروا به. والذي حدث كان عكس ذلك تماما، إذ عولجت جراح الأسرى المصابين ونقلوا إلى القاهرة حيث تم استجوابهم من خبراء في اللغات السامية – أذكر منهم الدكتور حسن ظاظا أستاذ اللغات السامية بجامعة الإسكندرية – يتكلمون العبرية بفصاحة تفوق تصور أكثرهم لدرجة أن بعضهم أجهش بالبكاء عندما بهرته اللغة العبرية التي يتكلم بها المحقق المصري.
انتهى اليوم الأول بتحقيق الأهداف المحددة وتحولت مصر في ساعات معدودة من دولة تستجدي السلام إلى دولة تبدي استعدادها للتفاوض على سلام متكافئ وذلك بتعاون كل أفراد الشعب المصري الذين صاروا قدوة للأجيال التالية، ولعلي أعبر هنا بكل تواضع، تواضع من مر بتجربة مشابهة في عام ١٩٥٦ عندما تصدى الإعلام المصري للأكاذيب عندما هاجمت بريطانيا وفرنسا مصر، بعد أن سبقتهما إسرائيل بأيام كطعم، ولكن الرئيس جمال عبد الناصر اكتشف المخطط الشرير، وهو حصار الجيش المصري في سيناء بقطع وسائل إمداده عبر قناة السويس.
في هذه الظروف الحرجة في سنة 1956 كان لابد لكل مصري قادر على حمل السلاح أن يقوم بواجبه دون اعتبار للتضحيات المترتبة على ذلك. وكان من المتطوعين معي في كتيبة “كلية هندسة جامعة القاهرة” ممن أسعفتني الذاكرة بأسمائهم – وأعتذر لمن أذكرهم – علي الصعيدي (وزير الكهرباء فيما بعد) وفاروق المنصوري (الأستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط فيما بعد) ومصطفى الكردي (مهندس التفتيش بألمانيا فيما بعد) وحسن شعراوي (أمين جامعة القاهرة فيما بعد) وحوالي ١٥٠ من دفعة بكالوريوس الهندسة لم ينظروا لمستقبلهم الذي ينتظرهم بعد شهور قليلة ليكون كل منهم “باشمهندس” ولكن كانوا مقتنعين بأن التضحية – ولو كانت بالنفس – فهي تضحية تستحق.
وكان أكثر ما حفر في وجداني من ذكريات هذه الأيام هو تصفيق سكان الشوارع التي مرت بها قافلتنا – بعد انتهاء التدريب السريع – عندما لاحظوا مرور السيارات تحمل شبابا بالزي العسكري. ولم يكن سكان هذه المناطق يعرفون موعد خروج المتطوعين ولكن بفطرتهم أحسوا أن هؤلاء الشبان هم طلبة الجامعة في طريقهم إلى مواقع تمركزهم للدفاع عن الوطن، فهرعوا إلى الشرفات وأخذوا يصفقون بكل حماس لهؤلاء الذين يضحون بالنفيس في سبيل حماية الوطن.
بعد أن انتقلت كتيبتنا للمواقع المحددة لها وكنا نرى عن بُعد الحرائق التي خلفتها قاذفات القنابل البريطانية وننتظر اسقاط جنود المظلات البريطانيين – وكانوا يسمون أنفسهم “الشياطين الخضر” – ونتساءل ما هذا الشعور الغريب، الذي يختلف جذريا عن شعورك أثناء التدريب. عندما تكون في موقعك متوقعا في أي لحظة آلاف الأعداء المدربين ينزلون بمظلاتهم بعد أن يكون نصف زملائك قد استشهدوا خلال القذف الذي يسبق الإنزال، إنه قطعا شعور لا يعرفه إلا من واجهه، شعور بالعزة والكرامة ممتزج باليقين أن اللحظة القادمة قد تكون آخر لحظة في حياتك، ومع يقينك بذلك لا تخشى الإقدام إلى هذه اللحظة.
لست خبيرا عسكريا ولكني أردت بهذا السرد القصير تذكرة نفسي ببعض ما تعلمته في الأسابيع القليلة أثناء التدريب الذي سبق هذه الأحداث في خريف 1956، لأن الأخبار الكاذبة من ناحية الإذاعة البريطانية كانت تنهال علينا كل يوم … بل كل ساعة. لذلك تعودت التحقق من كل خبر أسمعه. ويبدو أن هذا التصرف يصلح لأن يكون نصيحة لشباب أيامنا في 2023 حيث تنتشر الأخبار الكاذبة مختبئة في داخل فقرات تبدوا صادقة لأول وهلة، ولكنها تحمل سموم افساد التفكير في ثناياها. أدعوا الله الحافظ الكريم أن يحفظ مصر من كل معتد أثيم. لقد نجحت مصر في صد الاعتداءات الغاشمة على مر التاريخ بفضل القيادة الرشيدة ومن واقع خلفية حضارتها المتأصلة، إنها مصر التي تمتد جذورها إلى أعماق التاريخ.
هانئ محمود النقراشي